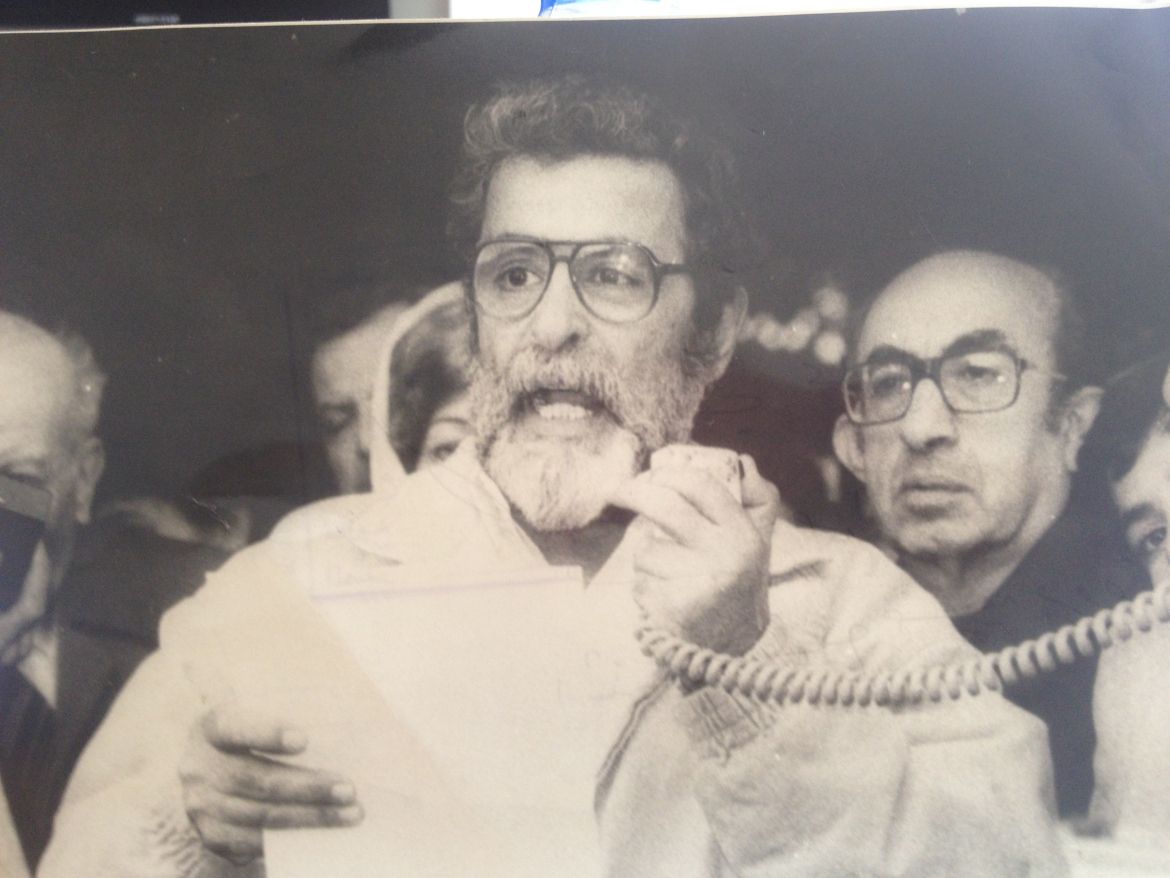19/ 5، بيروت (الغربية) في حالة إضراب عفوي فور انتشار الخبر. وبينما كان الشيوعيّون، والديمقراطيّون عامّة من أنصار الحركة الوطنيّة، يتقاطرون لتشييع الشهيد إلى مثواه الأخير، تداعى جمهور من المثقّفين، من كتّاب وفنّانين وإعلاميّين، ومن جامعيّين زملاء الشهيدَيْن خصوصاً، وتعاهدوا على اعتبار يوم 19 أيّار/ مايو من كلّ عام "يومَ الانتصار لحرّيّة التعبير والبحث العلمي في العالَم العربي".
***
انقضى ثلاثون وأربع سنوات ولم ينقطع إحياء الذكرى بأشكال ونشاطات مختلفة وبأعداد متفاوتة من المشاركين، بدمج أيّامها الثلاثة أو بتمايزها، بوجوه معهودة باقية على العهد، ووجوه يغيّبها مرور الوقت الذي لا مَرَدَّ له أو الانقطاع المؤقّت سعياً في سُبُل الحياة، ووجوه، أيضاً، شابّة، فَتِيّة، تتجدّد مع مرور الوقت. ويبقى في القلب من تعدّد النشاطات وأماكنها على امتداد الوطن، اجتماع ثُلّة من رفاق وأصدقاء حول أسرة الشهيد، لتجديد الزهور على ضريحه، والتأمّل الصامت.
إذا كان لنا أنْ نُشَخِّص روح هذه المقاومة المتواصلة على مدى ثُلث قرن، شمعةً لا تطفئها ريح، يحضر الوجه الذي يُفتقَد في الحراك، في سنته الرابعة والثلاثين، للمرّة الأولى وإلى الأبد، وجه إﻳﭭﻠﻴﻦ حمدان، شريكة حياة مهدي ودربه، وقد تحلَّتْ بالشَّجاعة والتَّحدّي للقيام بأعباء ما قد تعجز عنه مؤسّسات، فأحيت "مركز مهدي عامل الثقافي" وأدارت نشاطاته التي سدّت فراغاً ثقافياً في المجالين الفكري المتعلّق بقضايا حركة التحرّر الوطني ونظريّتها، والإبداعي عامّة، الشبابي منه خصوصاً، في لبنان والعالَم العربي. لكنْ يظلّ إنجازَ إﻳﭭﻠﻴﻦ الأهمَّ والأبقى، هذا العملُ الذي لم يعد في الإمكان فصلُه عن إرث مهدي عامل النظري والثقافي، كتاب المذكّرات/ السيرة: "رَجُلٌ في خُفَّيْن من نار"، الكتاب الذي صدر عن دار الفارابي ـ بيروت، بالفرنسيّة والعربية في مجلّد واحد (ترجمة د. رلى ذبيان)، والذي يُغذّي بأنوار ناره فَيْضاً من الإضاءات المتبادلة بين أحداث سيرة الرجل وإرثه الفكري، الإرث الذي بات من المحال استبعادُه من تاريخ ما أسماه مهدي نَفْسُه "الفكر العربي في صيرورته الماركسيّة اللينينيّة" ("مقدّمات نظريّة..." ط 5، 1986، ص 243).
مَن يقرإ الكتابَ، "رجلٌ في خفّين من نار"، يُدركْ أن حرارة لغته وأسلوبه لا تعود إلى الخوف على ناره من أن يُخمِدَها النسيانُ بفعل الوقت، بل، خصوصاً، إلى الغضب من فكرة احتمال أن يتحوّل إحياءُ الذكرى، كغيرها، بفعل العادة، إلى طقوسً تُخمِد حدساً لدى المؤلِّفة، رفيقة درب الرجل، من خوف على جيلٍ "فتيٍّ"، جيلٍ "آت"، حدساً لَمَسَه مهدي في حَدْب أبي نزار عليه في فُتوَّته، وعبّر عنه في رسالة مفتوحة (كتبها مهدي إثر قراءة "النزعات..."، أو إعادة قراءته، ونُشرتْ لاحقاً كملحق بكتاب مهدي عامل "أزمة الحضارة العربيّة أم أزمة البرجوازيّات العربيّة"، في طبعته الثالثة)، يقول: "لستُ إلّا واحداً من آخرين. كنّا للوعي نولد شيئاً فشيئاً في صفحات "الثقافة الوطنيّة" و"الأخبار". نكبر بسرعة في المظاهرات، وتتكاثر علينا الأسئلة. بصبرٍ كنتَ تُجيبُ، وبثقةٍ تدفعُنا إلى القراءة. كأنّك تنتظر. وكأنّ دربَكَ دربُنا الآتي (وقد يصحّ أنْ نقرأ: "دربُكَ دربَنا"، كما سيؤكِّد مهدي ضمناً في الكلمة التي ألقاها يوم تشييع أبي نزار إلى مثواه الأخير عند مقام السيّدة زينب في دمشق)، إنّه حدس المناضل، إذ يَرى بالقلب (يصحّ اليومَ أنْ نقرأ: حدس الشهيد)".
إنّها المسيرة تتواصل بتوالي أجيال على درب الشهادة، تشقّ طريقها بين متاهات الشعاب، يُلَمْلِم الشعبُ شَمْله من الشَّتات؛ يسري في عروق الوطن الدَّمُ المُهَرَاق، وبمِدادٍ من الوقت المهدور يَتَرَسَّمُ الحدُّ الذهني بين التاريخ وما قَبْلِه، وتُشرِق شمس التحرّر الوطني...
ينبغي الاعتراف هنا بأنّ النصّ هذا، جاء على شيءٍ من افتِعالٍ رومنطيقي لروحيّة في حركات التحرّر الوطني بدا لنا أنّها استحوَذَت على جُلّ جُهدِ مهدي، لاستخلاص أسرارها، في عمله الدؤوب على تسليح مناضليها بنظريّتها العلميّة. ففي المقدّمة المؤرّخة سنة 1975 للجزء الثاني، "في نمط الإنتاج الكولونيالي"، من "مقدّمات نظريّة..." (مصدر مذكور) يقول موضحاً إنّ "التطوّر الموضوعي للبحث في آليّة حركة التحرّر الوطني – وهذا هو الموضوع الأساسي للدراسة كلّها – تَبِعَ منطقاً مختلفاً هو منطقه الذي أرغمني على الدخول في قسم ثالث ما زلت أكتبه، فكان عليّ أنْ أجتزئ ما هو من الدراسة قسمها الثاني، والدراسة هذه واحدة في أقسامها الثلاثة...". ويمضي بالإيضاح قُدُماً في الفقرة الأخيرة من المقدّمة المذكورة، فيقول إنّ "حركة التحرّر الوطني هي موضوع الفكر في كلّ ما أكتب." ونزعم أنّ هذا يُخوِّلنا التعميم على كلّ نشاط مهدي النظري والثقافي: أكاديميّاً في محاضراته الجامعيّة، ومناضلاً شيوعيّاً في مداخلاته في الندوات والمنتديات العامّة والخاصّة، ومُبدِعاً يُقدِّم ذاتَه الحميمةَ مادّةً للتأمّل والتفكير، شاعراً في "فضاء النون"، أو ممثِّلاً على خشبة المسرح يَمْتَثِل لإدارة الكبير الراحل يعقوب الشدراوي (في دَوْر الشهيد الشيخ راغب حرب في "نزهة ريفيّة"، ودور مطران في "جبران والقاعدة")... متجاوزاً ثورة التحرّر الوطني بقلبه ولُبّه، إلى كلّ موقف ثوريّ ديمقراطي مع حزبه، وإلى كلّ حراك يُقيلُ شعبَه من عثرات صُنْعِ التاريخ.
هل من سبيل لتَواصُلٍ بالروح مع هذا الفرد الكلّيّ، هذا الذي يتجدّد حضوره اليوم "بخُفّين من نار"؟
الجواب في السيرة التي أشرعت الأبواب والنوافذ أمام باحثات وباحثين من الشباب للإفادة من ربط إرث الرجل بأحداث وتناقضات زمنه، بعين حاضرهم، على غرار منهج أبي نزار في دراسة التراث الفلسفي العربي الاسلامي، وهو المنهج الذي دعا مهدي إليه، وفي ضميره الطموح الذي لم يتحقّق في حياته: "الورشة الفكريّة" التي، كما عبّر في مقدّمة "نمط الانتاج الكولونيالي" المذكورة أعلاه، "يعود فيها الفرد إلى حجمه الطبيعي، ويكتشف حدوده ليلتقي مع آخرين في عمل بحثي يترابط ويتناقض، فيتكامل في شكل اجتماعي هو شكله العلمي". كانت خيبة مهدي كبيرة، وقد عبّر عنها بلا حرج مضيفاً: "ولم يأتِ النقد، بل أتى صمت لا أعلم – بل أعلم – تأويله فظلّ العمل حِرَفيّاً، وما زلتُ في المخاطرة".
لم يكن مهدي، في الأمس، ليقول هذا القول، بمثل ما قد يبدو عليه اليوم من دراما قديمة في نظر جيل جديد لا يُبالي. كان مهدي، في الأمس، يطالب بالنقد كحقّ من حقوقه، ويطلبه صريحاً، صادقاً، مسؤولاً. كان حقّ مهدي على قارئيه المسؤولين ألّا يبخلوا عليه بالنقد كما وجهاً لوجه، ولعلّه، اليوم، آتٍ كمناقشات تقطّع بها سبيل الوقت، ثمّ تجدّدتْ عَوْداً على بدء كأنّ شيئاً لم يكن، أو تواصلت بدءاً من حيث انقطعتْ، كجَمْرٍ تحت الرماد.