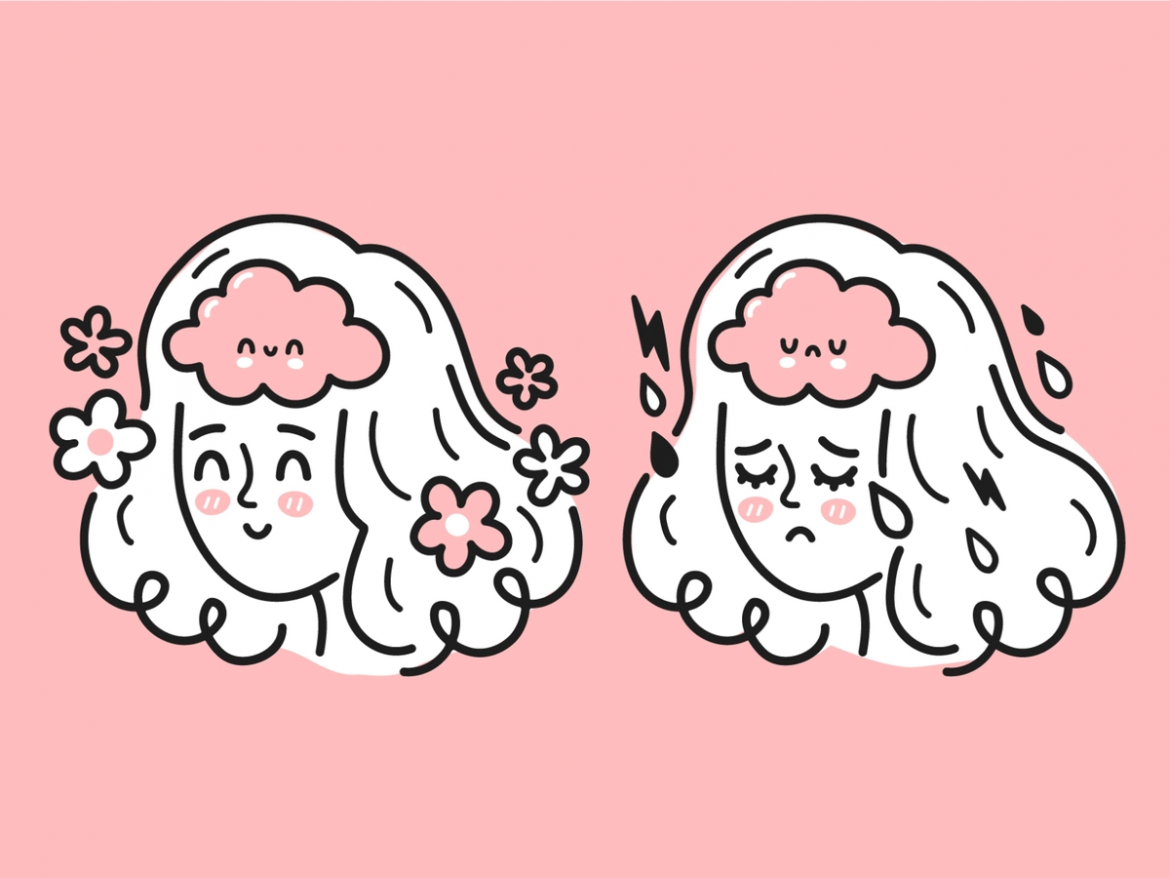وكانت هذه لتكون كذبة. لا اعلم لمَ أبدأ حديثي هذا باعتراف ومصارحة، ربما لأنني أريد ان اصارح نفسي... فأنا لدي الكثير من الوقت لكتابة هذا المقال، في الواقع انا ما عدتُ امتلك الّا الساعات الفارغة والأيام المتشابهة ووجهي الشاحب القلق. لو أنني لم اكتب هذا المقال أخيرًا كنتُ سأكذب واقول أنني اطعمتُ أصابعي لاحد اطفال الشوارع الجياع، أو أن الندم اليومي شلّ اليد اليمنى ولا استطيع الكتابة في اليُسرى. ربما كنتُ لأقول أنني علقتُ في غرفة لا كلمات فيها ولا افكار ولا طاقة، وما كنتُ لاكذب بذلك.
منذ عام تقريباً بدأت أعتاد على أني من أساسات البيت، يوم أكون مزهرية إتكالية تموت دون إهتمام خارجي، ويوم أعتاد الجلوس على كنبة الصالون فأصبح منها، ويوم أشعر أنني إحدى اللوحات المعلقة على الحائط... يمرّ الجميع من أمامي وربما ينظرون اليّ صدفة. منذ سنة تقريباً ما عادت مشاعري عادية، تطرّفت جميعها حدّ الجنون. أستيقظ صباحاً ولا أتذكر كيف غفوت الليلة السابقة، هل تعاركت مع احد قبل النوم؟ هل الجميع بخير؟ كيف انتهى بي المطاف في فراشي؟ وتأكلني الافكار لدقيقة قبل أن أستعيد ذاكرتي وأنهض عن الوسادة التي إبتلعت الكثير من خصال شعري، أنظفها قبل ان تراها أمي وتفزع ثم أزرع ابتسامة واجبة الحضور وأخرج من غرفتي. جميع الاحداث التي لم تنتهِ أصلاً، تبدأ لحظة خروجي من الغرفة، أحاول إضاءة الحمام ثم أتذكر أن لا كهرباء، أفتح المياه وأتذكر أن تلك الاخرى أيضاً غائبة منذ يومين، أنظر في المرآة وأنبّه نفسي أن النهار ما زال في أوله، "إبتسمي" أقول.. ثمّ أستخدم "جاط" لغسل وجهي على العتم.
ثم ماذا؟ تبدأ دوامة الفراغ المميتة، لا شيء ينتظرني... أعمل لساعة واحدة كصحافية في موقع إخباري، وفي هذه الساعة ألعب دور عزرائيل... هو يحمل الموت وأنا أحمل أخبار الموت، لكنني اسوأ اذ لا خلاص في الموت الذي أحمله أنا. في هذه الساعة، يتوجب عليّ قراءة أخبار البلد، أسعار المحروقات، إرتفاع الدولار، تصريحات هذا وبيانات ذاك، تخوفات كورونا، إحصاءات الفقر، تطورات الانهيار، جرائم الاغتصاب، قوانين التحرش البالية، أخبار اللاجئين والمهاجرين والشهداء، ضحايا الحروب والانفجارات والاغتيالات، و و و... ساعة واحدة كفيلة بإستنزاف الطاقة القليلة التي احتفظت بها من أحاديث أمي الصباحية، ساعة واحدة تخبرني أن البؤس لن ينتهي ما دام عالم الوحوش لم يمت ولا عالم جديد في الافق. هذه الساعة كفيلة لتؤكد لي أنني لو زرت جميع المعالجين في البلاد، لا أمل بالشفاء.
لا أقول هذا لأنتقص من أهمية زيارة معالج مختص قادر على تحسين وضع من هم بحاجة، أقول هذا محاولة مني للإضاءة على الصورة الأكبر من الفرد، فمعاناتي ليست فردية ولم تخصّني الحياة بهذه الاعباء دون غيري. معاناتي اتت نتيجة نظام لا يريد ان يرانا، يتغاضى عنا في أماكن العمل، في الشارع، في البيت، في الساحات حين نصرخ في وجهه.. يدوس على أجسادنا ويُكمل. نحن غير المرئيين، يتعثر بنا المرئيون كبحصة صغيرة على الرصيف، نضطر أحياناً أن نصرخ كي نُسمع فلا قيمة لصوتنا العادي، نضطر غالباً أن نلبس ثياباً كثيرة كي يصبح لنا جسداً، فبدونها لا إنعكاس لنا في المرايا والزجاج، ولا ظلّ لنا تحت الشمس. نحن الذين خلدنا الى النوم ذات ليلة وسرقت أحلامنا من تحت الوسادة، ولم نحلم من حينها... أصبحنا نخلد الى فراشنا كالخالد للعدم، مع القليل من الدموع والتنهيدات.
لم يكن مقدراً لهذا المقال أن يكتب، لكنني سئمت الحجج والتبريرات. لذا أنا أكتب، لاقول الحقيقة، والحقيقة هي أن أمتلك الكثير من الوقت لكنني لا أمتلك حرية التصرف فيه. منذ متى نتصرف بحرية تحت الرأسمالية؟